|
|
|
 آخر 10 مشاركات
آخر 10 مشاركات
|
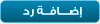 |
|
|
أدوات الموضوع | تقييم الموضوع | انواع عرض الموضوع |
|
|
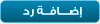 |
| الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|
|
|
|
 آخر 10 مشاركات
آخر 10 مشاركات
|
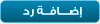 |
|
|
أدوات الموضوع | تقييم الموضوع | انواع عرض الموضوع |
|
|
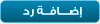 |
| الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|